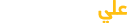نحن جيل بدوي تربى – غالبا – في كنف آباء أمّيين لايقرأون ولا يكتبون، ولا يعرفون ما الذي نقرأه ونكتبه في المدارس. لايعرفون نظريات جان بول سارتر التربوية، ولم تمر في أذهانهم فكرة الاقتران الشرطي، ولم يدرسوا علم نفس النمو.
آباء اعتبروا الشيوخ ورثة الأنبياء، وآمنوا بأن الدراسة شيء جيد “وإن ماحصل فما هو لازم”، مع اعتبار أن الذي لا يقرأ كالأعمى، وهذه عبارة كان يرددها أبي كثيرا.
آباء لم يقوموا بتربيتنا، وفق منهج تربوي أكاديمي، وسيدوخ متخصصون مثل ابراهيم الخليفي، وطارق الحبيب كثيرا في معرفة تلك المنهجية التربوية التي اعتمدت على حكمة (ودك الرّجّال يْغَـدي رجال).. (ولا تصير خبل يضحكون عليك الرياجيل)، (وامسك الدلة بيدك اليسار، والفنجان بيدك اليمين… وتركّد، لا تصير مطفوق)!!.
هؤلاء الآباء غفر الله لهم، وأسكنهم فسيح جناته لم يتعبوا كثيرا في التربية، فقد رمونا إلى الشارع لنتعلم منه (والحافظ الله)، (وإذا ما تعلمت من أبوك “وانا ابوك”… الدنيا تراها بتعلمك).
كان الشارع أقل خبثا ومجونا من شوارع اليوم، وأكثر براءة بكثير على سلبياته.
والحمد لله أنني ظهرت من الشارع بملابس نظيفة وسيرة طيبة، فقد تفوقت في دراستي، وتعودت على الهدوء، واكتفيت بصداقات قليلة، شتّـتتها الأيام.
ورغم البيئة المحافظة لم يتوفر لي وازع ديني قوي، فقانون “العيب والمنقود” كان هو المتصدر على حساب تعاليم الحلال والحرام، والحمد لله على كل حال.
ويبدو أن الطفولة المحافظة والملتزمة، يظهر لها نزق خاص عند المراهقة،
فعندما وصلت إلى سن الـ 18 بدأت أفكر بالتدخين، كأنما ذلك تطبيق لنظرية بعض الشيبان حول اولادهم (كبرت ودبرت)، على أنني أحفظ كلمة قالها لي والد صديقي الغاضب عندما شاهدني مع ولده نلعب في التراب، وقد توسخت ملابس ولده فصب جام غضبه علي وهو يقول لي بلهجة أسلمية: (انت… حليله حليله، لين كبر وصار بردحيله)!!.
وها أنا كبرت ودبرت…
لكن كيف تم لي ذلك؟
هل تذكر يا (شعيب)؟
طبعا لا تذكر
ولا تعرف…
فمشاغلك العسكرية سابقا، والنيابية حاليا لن تدعك تتذكر وسوف تتفاجأ، مثلما سأتفاجأ أنا بعد سنوات بشاب سيأتيني: ويقول لي انا دخنت بسببك، فكنت معجبا بك، او بطريقة تدخينك، أو لسبب ما.. قلدتك؟ ماذا اقول في تلك اللحظة لمن كنت له قدوة سيئة؟.
هل تذكر يا شعيب؟، ذلك الولد النحيل الذي “دوخّته الدنيا”، وكان يأتي إلى مكتبك قبل 25 عاما، وكنت أنت (ضابط قد الدنيا) تأتيك الأفواج، لا زلت أذكرك… كان كلامك لطيفا مع الجميع لكنك لم تعرني انتباها.
كنت تقوم وتقعد مع ابناء المسؤولين الذين يأتونك، وتوصلهم إلى الباب تودعهم بأجمل الابتسامات، وأرقّ العبارات، وانسحب أنا بخيبة، دون توديع ودون اعتذار.
هل تذكر انك كنت تدخن (ميريت أصفر)؟
أعجبتني اناقة علبة السجائر ..والقذارة دائما تأتي أنيقة… (زجاجات الخمر، علب السجائر، المومسات، وكبار المسؤولين الأفاقين). موت مغلف بأغلفة فاخرة، ووسخ مطلي بورق مصقول. (ولهذا ركز الاسلام على النظافة، والطهارة أكثر من تركيزه على الأناقة).
اشتريت علبة… وسحبت أول نفس…
… فماذا حدث؟
نوبة سعال امتدت يوما كاملا،ورائحة نتنة.
الله يسامحكما يا (م) و (خ).
صديقاي اللذان شجعاني على التدخين.
والشيطان “شيطان”، يبدأ معك بخطوة صغيرة، تكبر وتكبر وتكبر.. (ولا تتبعوا خطوات الشيطان).
لم اسمع نصيحة (غانم): اتركها، والله انك ستندم على أول سيجارة في عمرك!.
وكبرت… وأصبح الباكيت لا يفارقني، أحمر، وأصفر، وأبيض، وصدر يتحشرج، وأسنان تصفر، ومتعة زائفة، وسنين وأنا في صراع مع السم الملفوف بلفافته الأنيقة.
أتركها ثلث ساعة… ثم أعود إليها. أصبر عنها يوما، وأرجع نادما معتذرا: (ما أحلى الرجوع إليه).
ومن نعم الله العظيمة عليّ، أنني فطرت على حب المساجد، منذ “مبطي”. أرتاح لرائحة التسبيح التي تعبق بها باحات بيوت الله. أحب عبقها، سجّادها، مصاحفها، هواءها البارد، الوجوه الصافية فيها.
قلبي يخفق كلما دخلت برجلي اليمنى، وهمست: (اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك). أكاد أرى أبواب الرحمة تناديني باباً باباً، فالله سبحانه لم يعلمنا، إلا ليدلنا على المفاتيح التي تفتح الأبواب، لتهبّ نفحات رحماته.
لكن السيجارة كانت عائقا كبيرا أمام دخولي المسجد، فالرسول الكريم أمر بإخراج آكل البصل إلى مقابر البقيع.
وكم مررت أمام بيت من بيوت الله، والأذان العذب يصدح: “حي على الفلاح”، بينما كانت سيارتي تعج برائحة التبغ المحترق، فأحتار هل أترك النداء الإلهي، ام ألج وأدوّخ عباد الرحمن بنتن الشيطان؟.
قلبي يقول لي: المسجد..
نفسي تقول لي: السيجارة..
(قال ابن الجوزي: والنفس كالمرأة العاصية في المداراة والسياسة، فهي تُدارى عند نشوزها بالوعظ، فإذا لم تصلح فبالهجر، فإن لم تصلح فبالضرب، وليس في سياط التأديب أنفع من العزم والمجاهدة والمنع).
تأمّلت نفسي، واستسلمت لها السوط…!.