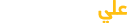تندلق حرارة القص في مجموعة علي المسعودي الأخير "تقاطيع" إليك عبر الكلمات الساخنة الطازجة التي يستخدمها القاص بتوهج عفوي خاص. والمسعودي قاص ينتمي لما يمكن أن نسميه جيل التسعينات على صعيد كتابة القصة القصيرة في الكويت، رغم أن هذا الجيل لم يجهد نفسه كثيرا في تمييز مرحلة بما يمكن أن يسمها فنيا ونقديا، بسمات تحدد هويتها بشكل كامل. ويبدو المسعودي في هذا الإطار واحدا من قلة قليلة جدا، أصرت علي الاستمرار في كتابة القصة القصيرة التي اتخذها بعضهم مدخلا لكتابة الرواية، وبعد آخر مدخلا للكتابة الصحفية المحترفة، وبعض ثالث مدخلا للخروج "يا للمفارقة!" من بوتقة الكتابة بكاملها.
بعد مجموعتين قصصيتين سابقتين يبدو المسعودي أكثر حرفية في التعامل مع قصته في المطلق. إنه لا ينتظر كثيرا للبحث عن مفردة أنسب لهذه الجملة، أو صفة أكثر دقة لتلك الكلمة ، أو حتى عن جملة أكثر أناقة من غيرها، فهو كالقابض على الجمر .. يريد التخلص منه بأقصى سرعة ممكنة فينثر في سبيل ذلك في الريح وهو ما زال كامدا بأطراف ملتهبه وقلب أسود، وما هي إلا هنية حتى تكمل حركة الريح الجامحة الطموح فعل الأشتعال، ليصير الجمر نارا متوهجة بالمفردة ومشعة بالمعنى رغم أنها أحيانا تحترق بأسرع مما ينبغي كي لا تترك أمامنا سوى ذلك الرماد الأبيض المزرق تذروه الرياح التي ساهمت في نهايتة السريعة.
في قصصه القلقة ، سريعة القراءة وبطيئة المفعول ، ينفتح على عوالمه الداخلية بأمانة وصدق، كمن يحاول أن يقلب أمامنا كتلته الجسدية بالكامل .. فيصير داخله هو الخارج. ويصير خارجه هو الداخل. وهو لا يجهد نفسه كثيرا في البحث عن "تيمات" أو موضوعات لقصصه القصيرة .. إنه فقط يسترجع ويتذكر ويكتب النتيجة مفترضا ذكاء إضافيا في قارئه، حتى يكون دائما معه في استرجاعه وتذكره وطريقته في الكتابة. حتى ليتساءل القارئ: هل يحتاج علي المسعودي إلى قارئ فعلا؟!
على أن السؤال الأسبق : هل هو يكتب فعلا؟ أم أنه يستدعي من الذاكرة أحداثا لا يجهد نفسه في تأليفها من جديد، بقدر ما يحاول بث روح جديدة بين تضاعيفها القديمة، مستعينا بقدرة عالية على الاحتفاء الموضوعي بموضوعاته البسيطة وتشكيلة تشكيلا متدرج النمو؟.
لا يبدو أننا – كمتلقين – بحاجة إلى إجابة عن هذه الأسئلة، بقدر ما نحن بحاجة إلى اكتشاف سر صغير يتمترس وراءه المؤلف، ليس بصفته القاص أو المنتج لهذه القصص وحسب، ولكن أيضا بصفته – كراو هذه المرة – الشخصية المحورية في كل القصص. فهو البطل الأوحد، وهو الموضوع الرئيسي، في حين يتحول الآخرون إلى مجرد شخصيات هامشية تساعد على اتضاح وبيان نمو الشخصية الرئيسية، ولكنها لا تشارك في بنائها أو نموها أو حتى تفعيلها في خضم الأحداث التي غالبا ما تكون استرجاعية نفسية، تتكئ على عوالم طفوليه بعيدة من دون الاهتمام بكشف أسرارها للقارئ الراهن.
تقاطيع أم تقطيعات
تحيل لحظة تقاطيع التي أختارها القاص عنوانا لمجموعته القصصية في الوهلة الأولى، وعبر القراءة العامية لها، لمعنى "ملامح" فتقاطيع الوجه هي ملامحه الأساسية أو هي بصمته التي بواسطتها يتميز عن غيرة من الوجوه، والوجوه هي مقدمات الكتل البشرية الأولى وعناوينها الخارجية اللافتة، ويمضي بنا دخولا نحو هذا الفهم الخاص إصرار شكلاني من القاص قبل الولوج في قراءتنا – وربما في كتاباته – على تثبيت هذا المعنى الدقيق والعامي لعنوان مجموعته، عبر أكثر من فعل، سواء أكان ذلك على صعيد "شكل" المجموعة القصصية النهائي ككتاب، أم على صعيد "شكل" الكتابة في هامشها ومتنها، فهو اختيار مثلا أن يجمع في غلاف المجموعة – التي يبدو أنه صممه بنفسه في ظل عدم وجود ما يشير إلى مصمم أخر – تفصيلات مختلفة لمنحوتة وجه بشري، وقد اختار المصمم من ملمح الوجه ما يذكر بالمقدرات المعرفية لهذا الوجه، فالعينان تشيران إلى البصر والأذنان إلى السمع، أما الفم يشير إلى الكلام، وإذا كانت حكمة القرود الصينية القديمة تصر على أنها لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم، فغلاف الكتاب الذي بين أيدينا يبدو عبر غلاف وكأنه يشير إلى إصراره على السم والبصر والكلام. ومقدرته على الكلام تبدو مضاعفة عبر تكرار لتفصيلة الفم بما يتوافق مع التكرار الطبيعي لتفصيلة العينين وتفصيلة الأذنين.
ولفظة "تقاطيع" تحيلنا إلى تقاطيع أو ملامح أخرى، وهي تقاطيع الكاتب أو ملامحه الشخصية هذه المرة، والتي أثبتها عبر صورة فوتوغرافية في الصفحة الأولى لكتابه، ثم ألحقها في الصفحة التالية بإهداء "إلى حسن واحمد وأخت غائبة وأخت تكاد تغيب" ثم صفحة ابتدائية أخرى يستلها القاص من رواية "كائن لا تحتمل خفته" لميلان كونديرا يقول في بعضها "اليوم، كف الجسد. بالتأكيد. عن أن يكون لغزا، فالذي يدق في الصدر هو القلب كما نعرف، والأنف ليس إلا نهاية القصبة الناتئة عن الجسد التي توصل الأكسجين إلى الرئتين. أما الوجه فهو لوحة الضفة التي ترسو عليها أعمال الجسد كلها: الهضم والنظر والسمع والنفس والتفكير".
الوجه، إذن بصفته، وفق كونديرا، لوحة الضفة التي ترسو عليها أعمال الجسد كلها، هو كلمة السر التي تدور حولها معظم أحداث هذه القصص القصيرة، وتبحث عنها معظم الشخصيات المتوحدة مع ذات وحيدة على مدى المجموعة كلها.
وهو على أية حال دوران لا يفضي إلا إلى المزيد من الدوران في حلقات مفرغة من الأسئلة التي تبدو مستحيلة الأجوبة، رغم رفاهية البادية، وبساطتها المستشفة، وأحيانا رغم مباشرتها المستمدة من اقتصاد لغوي غير مجاني في أغلبه، يصر عليه القاص في معظم قصصه، وإن كان يفشل في توظيفها أحيانا بما يمكن أن يقود القصة إلى احتمالات أكثر أتساعا في أفقها العام لدى القارئ.
مفارقة استهلاكية
في قصة "مواجهة" التي لا أدري لماذا أخرها القاص في ترتيب قصصة إلى أن تكون القصة قبل الأخيرة، رغم أنها تحمل
بين طياتها أكثر من ثغرة يمكن أن ينفذ من خلالها من يريد قراءة القصص الأخرى! – في هذه القصة بالذات يبدو القاص في كامل لياقته الفنية على صعيد خلق الحدث وتنامي عناصرة الأولية وتراكم ملامح الشخصية الرئيسة فيه شيئا فشيئا، رغم أن المفارقة التي حملتها السطور الأخيرة أحرقت، بطبيعتها الاستهلاكية، الكثير من رفاهة القصة، وساعدت على إحالة اللغة لأن تكون ذات ميزة أكروباتية في البداية للمحافظة على "السر" الذي يفضحه القارئ بشكل مجاني غير مبرر في النهاية.
ورغم أن القاص يفتتح قصته باستفهام مفرط في اقتصادة اللغوي مع اتساع احتمالاته المضمونية على أكثرمن أفق، عبر كلمة واحدة اتبعها بعلامة استفهام أحالت المفردة المحايدة إلى سؤال محمل بأكثر من احتمال مفتوح، إلا أن النهاية "تطوعت" بالإجابة عن احتمال واحد، وتركت لنا البقية، مما ساهم في اختزال بعض الاحتمالات التي دارت في فلكها الكلمة الافتتاحية الاستفهامية.
يبدأ القاص قصته هكذا:
" بالضبط ؟
.. لا أستطيع تحديد شعوري تجاهه، لأنني – أصلا- لا أعرف شعوره تجاهي.
الخضوع لإغراء المفارقة
النهائية أضاع القصص
وأحرق لغتها أحيانا
هل يتجاهلني .. كما يراودني الإحساس أحيانا؟
هل يهمه أمري .. حسبما يؤكد لي دائما؟
هل أقول بعد كل المصائب التي سببها لي – إنه يكرهني؟
تتزاحم حزم الأسئلة وتتدافع في نفسي، وتلبسني شخصيه في كل حياته.."
وتنتهي القصة هكذا:
".. وفور انشطار باب المصعد في الدور السادس يلطمني باب شقته المواجه .. وتلك اللوحة الصفراء المعلقة في الأعلى تحمل اسمه " علي المسعودي "!
أدير المفتاح .. أدفع الباب.. وأدخل إليه". وربما يبدو أكثر من معنى للقول إن القاص – علي المسعودي – لم يكن أبدا بحاجة لهذا المباشرة التوضيحية، ما دام مصرا في بقية قصصه على القارئ ذكي للتعاطي مع النهايات فيها، ليس وفقا لما تشي به البدايات بقدر ما تحرض على استنتاجه هذه البدايات.
" وجهة نظر" .. صياغة أخرى
وهذا ما بدا أكثر في "وجهة نظر" التي هي صيغة أخرى لحكاية القصة الأولى، وإن كان ذلك بشكل أكثر نضوجا واكتمالا فنيا، رغم إفراط القاص في هذه القصة في تحقيق فكرة الاقتصاد اللغوي على حساب الصورة الكلية، حيث سطور قليلة جدا تبدأ بمفتاح ذكي جدا يتكئ على الآخرين لتحقيق الفكرة الرئيسية: "يحدثونني دائما عن ذلك الشبه الكبير بيني وبينه.." وتنتهي بعبارة ملتبسة تتكئ على الآخرين أيضا: "..لم يقل لي أحد بعد ذلك إنني أشبهه"، وبين العبارتين أكثر من صفة وملمح "للحضور" الجسدي الذي يصر عليه المسعودي من الغلاف إلى الغلاف في هذه المجموعة، ورغم إصرار القاص على تحقق هذا الحضور عبر أكثر من وسيلة فنية، إلا أنه لا يمانع أبدا في إسناد مهمة تمييزه وتحديده إلى " الآخرين" الذين بحضورهم يتميز حضور الفرد وتتحدد ملامحه الأخيرة إما بالمقارنة أو بالمفارقة، أو حتى بالتشبيه.
ويبدو القاص في خضم المجموعة خاضعا لإغراء المفارقة النهائية في اختتام القصة، فرغم أنه لا يبدو حريصا على تحديد دقيق للبدايات التي تبدو منفلتة من عقال الزمان والمكان، إلا أن حرصه يصير مضاعفا في تحديد النهايات عبر اختراقات لغوية تبدو صاخبة وباهرة الضوء أحيانا، وخافتة ومبهمة في أحيان أخرى.
ولكنها في كل الحالات تبدو أكثر وضوحا في القسم الثاني من المجموعة والمعنون بـ "مناظر داخلية" وهي عبارة عن تسع قصص تبدو في كثير من الأحيان عبارة عن صياغات مختلفة، وبأساليب متشابهة لتيمة قصصية واحد تحفر في خضم الحضور الذاتي، وتحاور عناصر تحققه، وتحاول التقاط مشاهد مقربة من مختلف جهاته عبر "ابتسامات الثلج" حيث تنتهي القصة بـ "رأيت ما أفزعني : ابتسامته تنطبع على وجوههم، رأيت ما أفزعني أكثر: وجهي يحمل ابتسامة الجرسون!!"
وقصة "توحد" التي تنتهي بـ"ولكن ما هالني.. أنني رأيتها اليوم معا، وكل منهما يتلبس وجه الآخر" وقصة "ليل ..ربما" حيث تنتهي بـ"أشعر بالمرايا تقفز من الحيطان، وتحملني جسدا مضيئا.. يشبهني ليلا. وفي النهار أركض بحثا عنه.. لا أجده. أنوي اكتشاف موضعي.. لا أجدني، إذ يفتضح أمري أمام الملأ .. فينطفئ ما أحمل من ضوء .. وأتخفى". بـ" بدأت ملامحي تغيب، أنظر يدي فلا أجدها عن جسدي فلا أجده، أتكلم فلا أسمع صوتي، أنظر فلا أرى شيئا. تهت تهت في نفسي"، وقصة "حالة تصوير" التي تنتهي بـ" .. بعد يومين ظهرت الصورة وفيها وجهه البشع! .. طفرت مني: تفووه!" وفي قصة "تضاريس" على الأرجح" تنتهي بـ" ابحث عن أمك وطفولتك في تضاريس العباءة .. ولا تجبها .." وفي قصة "نكبر نتلوث" تنتهي بـ"و" .. "وخجلت أن تكمل جملتك؟".
مفردات الرؤية
نستطيع من خلا قراءتنا لتلك النهايات المرصودة اكتشاف معنى واحد لم يحرص القاص على إخفائه كثيرا، وهو ذلك المعنى المتمحور حول مفردات الرؤية والاكتشاف والانفضاح، والنظر، والظهور. إن القاص – وهو الشخصية المحورية للمجموعة بأسرها – يمارس فعل الكشف الذاتي بوسائله الذاتية في الوقت ذاته، فلا تكون النتيجة سوى مزيد من الغموض الجديد، فمفاتيحه التي تتخذ غالبا الجسد، أو على الأقل نت الحضور الجسدي، مرجعيتها الأساسية تنجح في فتح الأقفال الموصدة على طفولة خبيئة ومكتنزة بذكريات ناقصة وتهاويم غير مشذبة لتفاصيل تاريخ بعيد رغم حضوره المؤثر في الحاضر الحي، ولكنها في الوقت نفسه تتفتح على المزيد من الدهاليز الطويلة المفضية إلى غرف نفسه مضطر للاختباء وراء حيلة النهايات المفتوحة جزئيا في "مناظره داخليه" التسعة تحديدا؟!.
هذا لا يحدث على الأقل في " مناظره الخارجية" الأربعة التي بدأ القاص مجموعته بها، على عكس المتوقع في الترتيب المنطقي، لانطلاق الأشياء غالبا من الداخل إلى الخارج، فترتيب القصص القصيرة في هذه المجموعة يبدأ من الخارج، أي بمعنى آخر يبدأ من الآخر حيث الوضوح المضمون والواقع المحدد بكتل الآخرين وأحجامهم وتفاصيلهم والتواريخ المتعلقة بهم، نحو الداخل حيث تقبع الذات وحيدة مكلومة ومنطوية على تفاصيلها الغائمة وشكلها غير المحدد وحجمها المتمدد في زمانات ومكانات غير نهائية.
فالآخر هنا يساعد على تأكيد الأنا، والحضور الواقعي يؤكد وجود الغياب التاريخي، ومن خلال هذا الفهم يكتسب فعل المحو في أولى قصص المجموعة المعنونه بـ" سيد المحو" معنى إضافيا يدل على المحو في سبيل إعادة الكتابة، أو التغييب في سبيل إعادة الحضور:
"سلك طرقا متعرجة .. ولاذ بالفرار. لم تحتضنه سوى الصحراء ابتلعها .. حتى جرذني.
وقبض على يدي بمخالبه وهو يصرخ بصوت محشرج: ماذا تفعل ؟
قلت : سأكتبك ..
قال : لن تفعل ..
قلت : سأكتبك ..
قال : لن تفعل ..
كتبته ..
فمحاني !!"
وتنتهي القصة هكذا، لكن الأنا فيها تحققت بالفعل عبر فعل المحو المقصود بدلا من أن تغيب. تحققت في القصص الثلاث التالية كما لم تتوقع الأنا نفسها!!
أفعال سلبية
تحققت عبر كل الأفعال السلبية المعنى فيها، وبصيغ مختلفة كثيرة، فهي تلك النشوة النهائية المتحصلة للراقصة والطبال
مرجعية الجسد تنجح
في فتح الأقفال الموصدة
على طفولة خبيئة
على دوي الطبلة المضروبة بكل العنف في قصة " نشوة" حيث العلاقة الواضحة في شكلها الخارجي بين أثنين يتحقق وجودهما بالتبادل اللحظوي، بين ما يؤديان من فعلي التطبيل والرقص حيث أحدهما تحقيق للآخر من دون ترتيب، فمن يحقق من ؟ ومن ينهي من؟ وكيف تعيش المذبوحة تتلوى على أنغام الضارب الميت؟ .."فاضرب أيها الطبال.. اضرب ودعها تتلوى كالمذبوحة.
مت ودعها تحيا
اقتل رجولتك .. فداء أنوثتها.
اضرب الطبل الأجوف، اضرب نفسك .. ودعها تتلوى في الدوي الفارغ.
اشهق واضرب .."
لك النشوة التي تحققت في هذه القصة
تغيب في قصة أخرى من قصص "مناظر خارجية " رغم أن التحقيق ذاته يجيء من نفس المصدر، الفعل السلبي.
في قصة "خارج الحالة" حيث " .. يمر الليل بلا نشوة، ولا حرقة انتظار، أو ترقب. وأمر دون اندفاع أو خفقة قلب الشاطئ الخليج الذي يستقبل من الشمس قبلة طويلة من الضفة الأخرى، أتلوى مع الطريق الهادئ
أمر إلى جانب الأبراج دون التفات أو تفاؤل، في مرآة السيارة الداخلية أبراج تتقهقر، مثل أصدقاء ثلاثة فتاة وفتاه بعيدة واقفة تنتظر. المكان يبتعد .. وابتعد معه".
ومرة أخرى تنتهي القصة لكن "أنا" الشخصية المحورية فيها لا تبتعد بالفعل بقدر ما تحاول الاختباء عن "الآخر" الذي تعرف أنها لن تتحقق بدونه رغم أنه هنا ليس سوى بضع أخريات يحاولن كسر الحاجز بينه وبينهن، ويلجن إليه عبر "أحداث غير مهمة" لذا فهي مثبتة في مقدمة القصة، سوى من خلال سطور من الفراغ يبدو القاص حريصا على إثبات شكلها السلبي، ربما انسياقا وراء لعبته الكتابية المفضلة: التحقق من خلال الغياب، أو الغياب وراء ما هو متحقق فعلا! وهو الخيار الغريب الذي ينطرح على أرضية قصة الوهم ذاته بإحساس آخر" والتي حرص القاص على استخدام الفعل المضارع في كل جملها الأبتدائية حرصا منه كما يبدو على زرع الوهم نفسه وإن كان ذلك بإحساس آخر حتى لدى الملتقى.
في هذه القصة تتكشف فجأة أمام بطلها حقيقة مؤلمة بسيطة: كان دائما يحرص على قفل باب مؤسسته قبل الخروج بطريقة معينة، لكنه في لحظة خاطفة، اكتشف إن تلك الطريقة لم تكن تعمل، وأنه أمضى أيامه "أو لياليه" السابقة كلها بوهم كذبة القفل الصغيرة، فماذا كانت النتيجة؟ .. وجد نفسه في تلك اللحظة أمام الخيار المتوفر: .. أعيشها الليلة إذن، فما المفرق الآن عما مضى؟
صفقت الباب ورائي ومضيت.
لم تعد لدي رغبة في السهر.
وعيناي لم يطأهما نوم .. الأمان لم يتوفر لي الليلة!! الفكرة هنا بسيطة، وربما تكررت كثيرا في قصص وموضوعات أدبية أخرى، لكن المسعودي نجح في أن يضفي عليها خصوصيته عبر جمله المبتورة ولغته الواضحة، محددة المفردات. لكن ما أفسد بعضا منها تلك الجمل الشارحة المباشرة التي لم تكن تتحملها رفاهة القصة، وبساطة فكرتها، مثل قوله: " فأي فزع يفتك بي بعد الحادثة البسيطة والأمان لم يتوفر الليلة".
وماذا بعد؟! تقاطيع، مجرد تقاطيع، تناوش الحضور وتهادن الغياب احتفاء نهائيا بالذات!