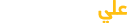في معرض حديثه عن نقض نظرية "الأنواع الأدبية" ، والتبشير بما أسماه "النص المفتوح"(1). يقول قاسم حداد في كتاب " ليس بهذا الشكل ولا بشكل آخر" بصدد حديثه عن مخطوطة أحد أصدقائه "تمنيت عليه ألا يكتب على غلافها بأنها رواية، فقد رأيت فيها نصاً جديداً مغايراً لمثل ذلك التصنيف، نصٌ يتمتعُ بحرية تخرجُ عن حدود الرواية بمفهومِها المتعارف عليه، فقد كان فيها من الشعر عناصرُ كثيرة(2)، ويبدو أن علي المسعودي حين دفع بكتابه للنشر رأى أن يأخذ أيضاً باقتراح قاسم حداد فلم يحددْ مجموعَته بمصطلح النوع الأدبي (قصص قصيرة). . وبذلك ترك القارئ أمام شكلٍ من الكتابة فيه من جرأة التجريب نصيب، ومن السياحة فيما بين الشعر والقص نصيبٌ آخر. شكلٌ مزجَ بين كثافةِ الشعر وإيغاله في الإيحاءِ والإيماض والنجوى المستسرّة، وبين ملامح القصة وما تقترحُهُ من ظلالِ أماكنٍ وشخوصٍ وأحداثٍ بدت هي الأخرى بعيدةً عن تقليدية القص ونمطيته، وجانحةً نحو خلقِ شروطِها غير المقيدةِ بتصنيف نظري جاهز. من هنا يجوزُ لنا أن نطلقَ هذا السؤال غير البريء مع قاسم حداد في كتابهِ سالف الذكر. والسؤال هو: ما الذي يمنحُ النص صفتَهُ وتصنيفَهُ النوعي، كأن نقول عن هذه المادة: قصة أو مسرحية أو قصيدة أو مقالة ؟! . . وهذا التساؤل قد يُحرضنا على التمرد ، وإعادة النظر في منظومةِ الأصولِ الموروثة، ويضعُنا أمام مغامرة " طرح القداسةِ عن تصنيفِ الأنواع الأدبية بحيث ينفتحُ الأفقُ واسعاً أمام الأجيال اللاحقة من المبدعين، لكي يقترحوا علينا إضافاتهم أو نقائضهم في أشكال التعبير، تلك الأشكال التي سوف تأخذُ دوماً شكلَ حياة البشر وطرائقَ تفكيرهم وأحلامَهم. إن فعل التبلور هذا لن يتوقفَ عبر المراحلِ التاريخيةِ المختلفة وهو تبلورٌ يتناقض مع فكرة الثبات المقدس، تبلورٌ يبقى مشتَعلاً في تأجيج طموح المبدعين لاكتشاف سُبلِ وأشكالِ تعبيرهم بمعزلٍ عن سلطةِ المقدس التي يسبغُها الكثيرون على التصنيفِ النوعي لأشكال الأدب(4).
قد يصلحُ هذا منطلقاً لاعتبارِ مجموعة علي المسعودي كتاباً يثيرُ التساؤلَ والجدل، ويلفتُ الانتباه باختلافهِ، وخروجهِ عن التقليديةِ والمشابهة، وبحثهِ عن شكلٍ ومضمون يأخذ أحدهما بخناقِ الآخر، يشاكسُهُ ويغويه ويراودهُ عن نفسه! ولكن هذا التصورَ الأوليَّ للمجموعةِ في كونها وعاءً تجريبياً طازجاً للنص المفتوح على الشعر والقصة، لن يصرفنا طبعاً عن تلمسِ أبعادِ المضمون في التجربةِ المتاحة بين أيدينا . . ولعل مفتاحَ المضمون يكمنُ بداهةً في عنوانها، وهو "تقاطيع" ولكن قبل محاولة فكِّ شيفرة هذا العنوان لنا أن نلقي نظرتين فاحصتين، الأولى على صورة الغلاف، والأخرى على التصدير. في مقدمة الكتاب الذي اقتبس من إحدى الروايات العالمية المترجمة. أما صورة الغلاف وهي العنصر الذي نادراً ما يُلفتُ انتباه الدارسين أو يثير فضولهم للبحث عن دلائل وخيوطٍ تعين على فهم النص الأدبي، رغم بداهة مشاركة المؤلف في اختيارها أو حتى تصميمها – نقول إن صورة الغلاف للمجموعة تصورُ تقاطيعَ مبعثرةً لوجهِ إنسان: عينٌ وأذنٌ وفم، وهي أعضاء لها صلةٌ مباشرة بالحسّ والشعور اللذين هما نافذة ٌ للعاطفة والفكر، فكما أن الوجه هو مرآةٌ للجسد هو أيضاً مرآةٌ للروح، وبه تتحددُ هويةُ الإنسان ويتمُّ عبرَهُ التواصلُ من الداخل إلى الخارج ومن الخارج إلى الداخل، هذا التصور للتكامل بين مدركاتِ حواس الإنسان المتمثلة بجسدهِ، ومدركاتِ روحِ الإنسان المتمثلة بعاطفته وفكره، يؤيدُهُ اقتباسُ المؤلف الآتي :
اليوم كفَّ الجسدُ بالتأكيد عن أن يكون لغزاً فالذي يدقُّ في الصدر هو القلب كما نعرف، والأنفُ ليس إلا نهاية القصبةِ الناتئةِ عن الجسد التي توصلُ الأوكسجين إلى الرئتين. أما الوجهُ فهو لوحةُ الضفة التي ترسو عليها أعمالُ الجسد كلُّها : الهضم والنظر والسمع والنفس والتفكير(5) . . "انتهى الاقتباس"
فالمجموعةُ إذاً ترجمةٌ لذاكرةِ الإنسان المتمثلة بالحواسِ والأفكار والمشاعر مجتمعةً، وتأكيدٌ على ماهية الإنسانية الكشفية والسابرة لغور عوالمها عبر هذه السبل المتاحة دون جنوح إلى ما وراءِ واقعِ هذا الإنسان وحدوده.
ولعله من قبيل المصادفة المفيدة أن تتزامنَ قراءتي لمجموعةِ "تقاطيع" . . مع قراءتي لرواية .. "ذاكرة الجسد " لأحلام مستغانمي. وقد يظنُ من يتوقفُ عند عنوان هذه الرواية، انها قد تكونُ محتفيةً احتفاء خاصاً بشطحات الجسد الحسيِّة وآفاقها الغامضة والدانية. ولكن من يقتربُ من هذا العمل الإبداعي سوف يكتشفُ أن "ذاكرةَ الجسد" ما هي إلا ذاكرةٌ تجمع بين المدركاتِ العقليةِ والنفسيةِ والحسية، وهي مدركاتٌ موغلةٌ في الضمير والشعور ومن خلالها يعلو حسن الانتماء إلى أزمنة وذكريات وشخوص وميراث وجداني خصب. وبذلك يتحول الجسد في مجموعة علي المسعودي ورواية مستغانمي إلى ذاتٍ كونية شاملة منطويةٍ داخلَ إطار الإنسانِ المحدودِ بجسده والشاسعِ بما يشعُّه هذا الجسدُ من عوالم.
أما إذا إتينا إلى التقسيم الهيكلي لنصوص المجموعة فيمكنُنا أن نبين نَوعين من التقسيم، الأول اختاره المؤلف عندما قسم النصوصَ إلى مجموعتين: مناظر خارجية وشملت أربعةَ نصوص، ومناظر داخلية وتشتمل على تسعةِ نصوص. أما المناظرُ الخارجية فهي في تصورنا تشيرُ إلى التجارب التي تخصُّ الآخرين أو العالم الذي يقعَ خارجَ حدود الذات الشاخصة، وقد يكونُ الكاتبُ واحداً من هؤلاء الآخرين أو مفردةً من منظومةِ العالم الذي يقعُ خارج حدود الذات. أما نصوص المناظر الداخلية فهي تمس بشكلٍ دال العالمَ النفسيَّ الداخلي للكاتب، ولكن هذا لا يمنع أيضاً أن يكون الآخرون جزءاً من هذا العالم.
أما التقسيمُ الآخر لنصوص المجموعةِ -وهو تقسيم فني ارتأيناه نحن حين تأملنا في سماتها الفنية- فيمكن أن يتشعب إلى قسمين: الأول نصوصٌ تشبه الشعر والثاني نصوصٌ تشبهُ القصة. ولعل الدخول إلى عوالمِ المجموعة من بوابة هذا التقسيم الفني يبدو لي أكثر ملائمةً، لأنه بالضرورة سيؤدي إلى تغطيةِ التقسيمِ الآخرِ للمؤلف ولن يجور عليه أو يلغيَه
أولُ نص يتقمصُ هيكلَ الشعر وروحَه ووقعَه النفسي هو نص "نشوة" الذي يمكن أن نلخصَ فحواه في ثلاثِ كلماتٍ وردت في النص وهي "مت . . ودعها تحيا" والميّتُ نقمة وغيرة وغضباً وألماً هو طبالُ الراقصة المغمورُ بالدونية والهامشية والصنعة، بينما هي تمضي راقصة فوق ألمه النافر ورجولته المسحوقة وتبعيته التامة لها. وعندها لا يملكُ من وسيلة للتنفيس عن ذلك الموران والغضب والرجولة المسحوقة أمام الأنوثة ذات الجبروت إلا بالضرب العنيف الصارخ على طبل أصبح صنوَ نفسه التي تستحق الجلد، أو صورة لمعذبته يتشفى منها بساديةٍ مطلقة: يقول النص: اجلدْها / صب عليها نقمتَك / مزقْ صدرَها المرتجف/ اضربْ أفعوانَ خصرها/ اجلدْها/ اهو على ظهرها وبطنِها بعصاك/ انهضْ بكل كبتك ولوعتك . واضرب/ اضرب .. اضرب / بعنفٍ اضرب /بحقدٍ بانتقامٍ، بلوعة .
اضرب حتى نفسك التي تستحقُ الضرب /اجلد جلدَك الميت المحاصر / اهوِ بعصاك على نفسِك وحطم رأسَك/ اضرب حتى روحَك /اضرب مكانَ كبريائك الفارغ اضرب أيها الطبال ودعها تتلوى كالمذبوحة .
وهكذا يمضي النص بكل شحنات الشعر لاهباً متوتراً، كثيفاً في إيحائه صاخباً في إيقاعه، متخذاً من الشحنة العاطفية بؤرةً ومنطلقاً، ومن تواتر الصورة واندياحها سمةً بارزة للنص . ثم هناك أيضا انصراف ملفت عن إغراءات السرد، وعن التفاصيل اللفظية المجانية، وعن التطفل على الحالة الشعورية الفائرة بتعقيب أو إضافة إنه نصٌ للطبال فقط، ونصٌ للغضب واللوعة والانسحاق ليس غير.
وقد اختار الكاتبُ أن يضعَ هذا النص "نشوة" ضمن النصوص المدرجة تحت "مناظرَ خارجية"، مشيراً بذلك إلى تجربةِ الآخر التي تقع خارج حدود ذاته، ولكنه رغم ذلك استطاع أن يتقمصها باقتدار ويبث فيها شجنَ الإنسان حين يتمثلُ تلاشيه وعجزه عبر جسرٍ من الاحترام والتوهج في ثلاثة نصوصٍ أخرى وهي : "ليلً ربما" و "ضفة ثانية" و"تضاريسُ على الأرجح". يخطو الكاتبُ نحو ذاته الشاخصة، يتفقدُها ويتلمسُ حدودَها، وغرابتَها، وتهاويمها وراء المغري والغامض من الذكرياتِ والصور، كما يفعل الشاعرُ تماماً إزاء رؤاه، وخيالاتِه الجانحة، وإحساسِه الغامرِ "بالأنا" وحضورها الملحّ. لذا فورودُ هذه النصوص المذكورةِ آنفاً تحت مجموعةِ "مناظر داخلية" جاء ليخدمَ هذا التوجهَ النفسي نحو الرغبةِ في البوح، يقول:
(في الليل، في عز العتمة، عندما ينهالُ الظلامُ على الظلام. ولا أشعرُ بجدوى عيني.. ظلامٌ دامسٌ أسود، وأنا انظرُ باتجاه المرآة، أشعر أنني أراني جيداً، ولا أخاف: أشعر بالمرايا تقفزُ من الحيطان، وتحملنُي جسداً مضيئاً يشبهُني ليلاً . وفي النهار أركضُ بحثاً عنه . . لاأجدُه، أنوي اكتشاف موضعي . . لا أجدُني . إذ يُفتضح أمري أمام الملأ . . فينطفئ ما أحملُ من ضوءٍ . . وأتخفّى)(8). انتهى .
هنـا فـي هذه الجمل القصيرة الكثيفة يختصرُ الكاتبُ معاناة الإنسان حين يقف ممزقاً بين حالين: حال تعرف الذات على "الأنا". . وتلمس أبعادها، وهي معرفةٌ فالرؤية القلبية لا تحتاج إلى إضاءة خارجية ، وإنما تتشكل هذه المعرفة باهرة وصادقة بين شجن الذات وتكمن مستسرَّةً، كجوهرة عارية إلا من بريقها. أما الحالُ الأخرى المغايرة. فتكمنُ في صعوبة تعرف الآخرين على هذه الذات أو حتى ملامستها.إذ تتحولُ -كما عبر الكاتب- في النهار إلى نكرةٍ وهباء، متضاءلةً تحت وطأة لا شيئيّتها:
. .في النهار أركضُ بحثاً عنه .. لا أجدُه، أنوي أكتشاف موضعي . . لا أجدُني. إذ يُفتضح أمري أمام الملأ. . فينطفئ ما أحمل من ضوء. . وأتخفّى . . إنه حالُ الإنسان الذي يذوبُ في ضوء النهار ويتلاشى لأنه يرى نفسَه بعيون الآخرين التي قد تُسيء الحكم أو تُخدعُ بالمظهر المتواضع، أو لا تعرفُ الإنسان إلا شكلاً ظاهرياً محدوداً . هذا الذوبان لجوهرة الذات وإنطفائها حين تلاشيها في صخب العالم الخارجي وجهله وظلمته، يبرزُ مرةً أخرى في نص: "ضفة ثانية" فيبدو المشهدُ شبيهاً بالخروج من غرفة مغلقة، نحو الشارع وهذه الغرفة المغلقة قد تكون مليئة بالغابات والذكريات والملذات، أو مطبقة على عتمة وموت مرعب وهي غرفة الذات أو "الأنا" ولكن حين الخروج منها إلى الشارع. . أو عالمِ الآخرين يبدأ الذوبان، والانعتاق الفارغ، يقول:
"دخلت الشارع، بدأتُ أنسربُ بين الناس، أصبحتُ أذوبُ بينهم، بدأت ملامحي تغيب. أنظرُ يدي فلا أجدُها، أبحث عن جسدي فلا أجدُه ، أتكلمُ فلا أسمعُ صوتي، أنظرُ فلا أرى شيئاً. تهتُ عن نفسي".(9) انتهى.
وكما يتيه الإنسان اغتراباً في عالم الآخرين – كما يعبّر علي المسعودي- فقد يجدُ نفسه في لحظةٍ ما، في موضعٍ ما، في زمنٍ ما، مندساً في حفيف رائحة غاربة، أو ملمس ثوب، أو في صورة مهوِّمة. فيقف أمام هذا الكشف لا يريم، متعرفاً على طعم الحنين وحميمية الالتصاق، وروعة اكتشاف الذات عبر الآخر ولعل خير ما يعبرُ عن لحظة الاهتداء هذه ما نجده في نص : "تضاريس على الأرجح" يقول: "لا تدري أيُّ حنين يأخُذك إليه السهو وأنت تغفو في أمان شاسع.
في العباءة . . هنا يرمي بك المكان الدافئ إلى حضن أمك الحنون، عندما تستلقي متوسداً ركبتَها، ورويداً يسرقكَ النعاس حتى تُسدل عليك العباءة . . فيدوّخك العطر الأخّاذ . . وتغفو في أجواء الجنة.
ابحث عن أمِّك وطفولتك في تضاريس العباءة" (10). انتهى.
في كل هذه الأمثلةِ مجتمعةً يبدأ النصُ شعراً وينتهي شعراً. يتكاثف النص، يتداخل، يتبلورُ في بؤرةِ اضاءةٍ كاشفة. وينتهي عندها، مكتملاً في نصفِ صفحةٍ فقط. إن ما يحرك الكاتبَ في الأمثلة المذكورة هو الدفقةُ الشعوريةُ العارمة، فينقبضُ عليها عاريةً من أثواب اللفظيةِ وجماليات الرّصف، رابئاً بها عن غوايات السرد وسحر الكلمة الواصفة أو المرادفة أو الفارغة الأثر. وإنما هو كشفٌ مركز عن بذرة التجربة الشعورية وروحها لا غير. ولهذه الأسباب رأينا – في هذه القراءة – أن ندرج أمثلة هذه النصوص تحت مسمى نصوص تشبه الشعر.
أما القسم الآخر من النصوص وهي التي سمّيناها نصوصا تشبه القصة، فنريدُ أيضاً أن نعيدَ التأكيد على تعبير "تشبه" لأن هذه النصوص رغم ما تضمه من ملامح، أماكن وشخوص وأحداث، إلا أنها بطريقة ما تقترحُ أسلوبها الخاص في التعامل مع هذه العناصر، بالإضافة إلى حرصها سالف الذكر على التركيز والمباشرة، واقتناص اللحظة الشعورية المكثفة. كما أنها أيضاً لم تتخلّ عن ايقاع الشعر وصوره وإيحائه.
في نص "سيد المحو" تركيزٌ ملحوظ على الصورة. والصورةُ إذ تتكونُ منذ مطلع النص، وتكبُر وتتسع فإنها تُشكلُ حضوراً طاغياً لكائن ما، كائنٍ أسطوري، مخيفٍ وكريه ومنطوٍ على الشراسة والجبروت. يقول "كائنٌ مشبعٌ بالأهوال، له قرنُ خرتيت، تسكنُ بطنه أفعى رمادية. . يرتدي العواصف. . يهوى الاستحمامَ في مستنقعاتٍ بترولية. . وينامُ ملء جفونه وسط القردة والتماسيح وأسماك القرش والخنازير.(11) انتهى.
ومنذ البدء يُشعرنا النص بوجود ثمة علاقةٍ قهريةٍ انتمائية بين هذا الكائن والشخصيةِ المقترحة التي تتحدثُ بلسان المتكلم، وهي علاقة قائمة على الانصياع والخضوع والاستلاب منذ الطفولة الباكرة، ووعاها بطل النص على مقاعد الدرس تلميذاً فربط بين المدرسة والبرد وبين المدرس والقسوة وبين حضور هذا الكائن (المرسوم على لوحة أو خارطة) وبين الخوفِ والارتعاد وفقدانِ الأمن -إن لم يكن الانسحاق- أمام جبروته وأذاه. وشيئاً فشيئاً يشع النص ويوحي بحقيقة هذا الكائن الذي كان يصفه الكاتب "يفتح فمه عن أسنان ذئب شرس" ويلف ذيله حول العنق" "ويطارد" و"يطلقُ الرصاص" أليست هذه صورة سلطة ما، مجتمع ما، وطنٍ.. ربما. وسواءً كانت صورةُ هذا الكائن القابضُ على المصير بمخالبه هذه أو تلك، فإنه كما يحسه الكاتب – لن يرعوي عن محو أولئك النابتين في أنحائه وإبادتهم كما تُباد الكائنات القميئة، أليس هو "سيد المحو" كما دعاه الكاتب في عنوان النص؟! أليس هو الذي قدم له الكاتب في مطلع النص بقوله . . نصف الحيوان ونصف الإنسان . . القويُّ الجبان . . الذي إن كشفت اسمَهُ اباح "دمي"؟ انتهى.
وكيف سيكشف اسمه إلا بالكتابة، الأداة المثلى للتعبيرِ عن الانسحاق والضياع: يقول:
وقبض على يدي بمخالبه وهو يصرخُ بصوت محُشرج: ماذا تفعل؟
قلت: سأكتُبك،قال: لن تفعل! قلت: سأكتُبك! قال: لن تفعل. كتبتُهُ.. فمحاني!(12)
وبذلكَ يظلُ هاجسُ التعرضِ للمحو والإبادة مقصلةً أخرى تعيدُ الذي يهمُّ بالفعل إلى ارتعادِه الأول وضآلته، حين كان تلميذاً صغيراً تهشُ عليه عصا المدرس، وترجُفه قشعريرةُ الفصل، ويهزُّ جدرانَ أمنه "سيد المحو" في إطار هذا الشعور العام بصفاقة الحياة، وبلادة مظاهرها، وإنطفاء الإنسان وفقدان أمنه ، وبراءته، تنمو نصوصٌ أخرى مثل "خارج الحالة"، "ابتسامات الثلج"، "الوهم ذاته، باحساس آخر" و"نكبر نتلوث" .
في نص "خارج الحالة " تبدو الدعوةُ للحب من امرأةٍ مجهولة، مفردةً من مفردات الحياة البليدة لا تثير في "المدعو إليها" فضولاً، أو تحفزه لكشف أو تجربة شعور آخر غير الركون والكآبة وفقدان شهية الحياة " هل تستطيع ورقةٌ مجهولةُ النسب غسل همومي؟.، لم يتحرك بي ساكن " يهاجمني الرماد" وحتى بعد أن اغتصبت منه الفتاة موعداً للقاء بعد لأي، جاءت الاستجابة بهذه الشاكلة: " أمرّ دونَ اندفاعٍ أو خفقة قلب على شاطئ الخليج . أتلوي مع الطريق الهادىء، أمرُّ إلى جانب الأبراجِ دون التفاتٍ أو تفاؤل، في مرآة السيارة الداخلية أبراجٌ تتقهقرُ مثل أصدقاء ثلاثة، وفتاةٌ بعيدة واقفةٌ تنتظر، المكانُ يبتعد . . وأبتعدُ معه.(13) انتهى.
وكما تفشلُ دعوةُ الحب في التخفيف من جهامة واقع مثقل بالكآبة واللاجدوى، تفشل أيضاً هالةُ الصخب التي يخلقها عنفوانُ شلة الشباب من الأصدقاء في فتح كوة للفرح في نص "ابتسامات الثلج" بل لعل الشعور بموات الحياة وإنطفاء جذوتها يباغتُ بطل النص عندما يكتشف أن كل ذلك الصخب والضحك والاندفاعات المتطرفة ما هي إلا قشور "فرح ظاهر" . ستر عورة " كآبة غائرة". وقد تم اكتشاف ذلك من خلال التوحد بشخصية "الجرسون" الذي أقبل لخدمتهم في مقهى أحد الفنادق. تلك الشخصية التي بُرمجت مظهرياً ببدلة أنيقة، وحركات مدروسة، وابتسامةٍ مرسومة محايدة. يقول: من بلد غريب جاءَ غريباً. . ليقدم ابتسامةٍ مجانيةٍ موجعة، سطحية، متكررة كنسخةٍ مصورة وموزعةٍ على الجميع تطابق الأصل، منفردة، لا تضفي فرحاً أو تدلُّ على فرح، الفمُ وحده ينفرج عن ابتسامة، بينما العينُ تغرق في توهان بعيد. (14)انتهى.
هذا التأملُ الفاحص للجرسون ليس سوى بدايةِ اكتشاف للذات من خلال التوحد بهذه الشخصية. فالجرسون صنو نفسه في آلية استجاباته وروحه المضببة الحائرة خلف إطار الأناقة والمرح المزيف . بل إن هذا الاكتشاف لا يشملُهُ هو فقط ويضعهُ في خانة النبت الشاذ، وإنما يبدو كوباء أصفر يمدُّ ذراعيه نحو الجميع، يقول :
نهضَ الأصدقاءُ للمغادرة، ونهضتُ معهم مبرمجاً، سرتُ صامتاً، وانحشرت معهم في السيارة المشتركة، وهم يغيبون في الضحك.
رأيتُ ما أفزعني: ابتسامتُهُ تنطبعُ على وجوهِهِم!
رأيتُ ما أفزعني أكثر: وجهي يحملُ ابتسامة الجرسون.(15) . انتهى.
ولعل الشعور بعبثية الحياة ولا جدواها يمتُّد ليشملَ ذلك الشعوّ بتزعزع الأمن النفسي وأن حس الطمأنينة الذي قد نركن إليه في بعض الممارسات الحياتية قد ينكشف عن وهم ، ففي الوهم ذاته بإحساس آخر يشيرُ إلى أن ما يصنعُهُ تصورنا على أنه حقيقةٌ مطلقة قد يكون وهماً.
ولكننا نظلّ نعيش في إطار هذا التصور الكاذب ونعدُّه حقيقة نستمدُ منها الأمن والركون إلى طمأنينة خادعة . فصاحب المؤسسة الذي يحرص على إغلاق باب مؤسسته بالمفتاح كل مساء لينام مطمئناً، يكتشف فجأة حين اختبار القفل أن البابَ لم يكن يُقفل كما كان يظن. هذا الاكتشاف وضعه فجأة أمام هذه الحقيقة " حرصي وخروجي وراحتي ثم نومي. . كله كان كذبة " لأن القفل كذبة(16).
وبالطريقة نفسها التي يُعبر فيها الكاتب عن أأن الأمن والطمأنينة وهمُ كاذب، يهجسُ أيضاً في نص "نكبر نتلوث" بأن البراءة والنقاء الإنساني حتى في الأطفال آيلان حتماً للاضمحلال. ألا يدبُّ الأطفال نحو هذا العالم الموبوء حين يكبرون؟ فما الذي سوف يمنعُهم من التلوث؟ ينطلق هذا الهاجس مهموماً فوق سجادة الصلاة، الصلاةُ التي لم تستطع أن تغسلُ أوراقَ العالم، تماماً كما لا تستطيع براءةُ وجوه الأطفال أن تصمد أمام تلوثهم الآتي حتماً.
من خلال النماذج النصية سالفة الذكر يبدو لنا أن الكاتب يشيدُ بناءً هرمياً يتصاعد بأناة نحو رسم تصورٍ للعالم وموضوع الإنسان فيه من وجهة نظر الأنا المسلحة بحواسها ومدركاتها ومعرفتها القلبية، ولكن يبدو أنه في لحظةٍ ما، في موقفٍ ما، يدركُ فداحة الاعتماد على النظرة الأحادية ليس في تقييمِ موقفهٍ من العالم حوله فقط، وإنما أيضاً في تقييمه لشخصه وماهيته ومن هنا يقوم الكاتب بمحاولة خلق "الشخص الثاني" أو "الهو" المنفصم عن "الأنا" للتخلص من أنانيةِ الذات ونظرتها الأحادية ومحاولةُ الانفصام هذه التي نراها في نص "مواجهة" تخلقُ حالة من الاختلاف والمغايرة قد تصل إلى حد التضاد بين "الأنا" و "الهو" . يقول الكاتب متقمصاً الشخص الثاني المنفصم عن "الأنا" والناظر إليها عن بعد: "أتذكر تصرفاته الغريبة، طموحاته، شبقهُ، سأمه من الحياة أحياناً، حبه الهائج، عنفه. . الرجال الذين يفرضهم عليَّ ولا أحب معايشتهم! والضعف الذي يشكل ملامحه، فتجتاحني شفقة البكاء عليه. عنفه وقوته، عنادُه المرُعب لأجل أشياء تافهةٍ يتمسك بها لدرجة الموت، فيورطني هكذا فجأة بلا أية مقدمات، وأجدني في فخاخ متشابكة لا فكاك منها.(17)
ومن هنا تبدأ مسألة إعادة الحسابات بعد هذا التقييم الذاتي الذي لا يشايع "الأنا" ولا يقف في صفها، بل ينتقدها نقداً مكشوفاً ولاذعاً، يختصره بعد سلسلة من الإدانات بكلمة " تخبط" التي تبدو هنا كسمة أساسية " للأنا". بل إن نقد الذات يزداد وضوحاً في نص "وجهة نظر" حين يعترف الكاتب بكراهيته لذلك الشخص الذي تفوق عليه في اللباقة والثقة بالنفس والحضور، وواراه في الظل فلم يعد يشبهه كما كان يدَّعي الناس.
ورغم هذه الحروب الصغيرة والمثيرة بين الضدين "الأنا" و"الهو" إلا أن الحنو على الذات والرغبة في معانقتها ، والعودة بها إلى حالة التوحد التي كانت عليها تنتصر في النهاية على حالة الانفصام، وتعود الأنا إلى حظيرتها وأثوابها السالفة، ورؤاها المعهودة الأليفة: يقول:
" أعودُ في المساء مندفعاً . . متلهفاً للجلوسِ إليه، ومناجاتِه، واستمالة رضاه، ومسامرته بمودة بيضاء . . أعودُ مسرعاً، أدخل مصعد البناية الضيق وأضغطُ من بين الأزرار على الرقم (6) وفورَ انشطار باب المصعد في الدور السادس، يلطمني باب شقتهِ المواجه. . وتلك اللوحةُ الصفراء المعلقة في الأعلى تحمل اسمه "علي المسعودي" أديرُ المفتاح "أدفع الباب". . وأدخل إليه. .(18)
وعلي المسعودي الذي لم يكتفِ بإدخالنا إلى شقته، وإنما أيضاً أدخلنا في دهاليز نفسه وغرف هواجسه، نراه في هذه المجموعة يعيدُ فن القصة إلى رحاب الذاتية حيناً والخصوصية الإنسانية حيناً آخر، متفيئاً به ظلال الشعر، ليس بتعريفه العروضي، وإنما بملامسته لتهويمات الإنسان وذهوله ولحظات كشفه. إنه لايحتفي بجماليات الأسلوب، وغوايات الصياغة، بقدر احتفائه بنبض التجربة العارية المباغتة، يقتنصها من مواد أولية: مواقف، لمحات، مشاهد، هواجس، يشخصُ في تراكمها، يقص زوائدها وذيولَها ثم يخلق منها كائناته الجديدة . إنها كتابة تختار ملامحها وتخلقُ إيقاعها الخاص، أو ربما يتأتيان لها طوعاً حين التجرؤ على تجاوز المألوف والمكرر من أنماط الكتابة.
إن رغبة الاختراق التعبيري عند المبدع هي ضرب من الموهبة الأساسية، وربما كانت هي واحدة من أهم مكونات الإبداع. وعبر التاريخ الإنساني، في مجال النشاط الفني والأدبي، كان التجديد والابتكار لا يتحققان بغير هذا النزوع الفطري عند المبدع، إنه في كل لحظة من التاريخ يجرّب بحرية ومسؤولية في هذا الاتجاه، وعليه أن يؤكد موهبته في التجربة.(19)
د. نجمة ادريس
(1) قاسم حداد، ليس بهذا الشكل ولابشكل آخر، دار قرطاس للنشر، ط1، الكويت، 1997، ص18
(2) نفسه، ص21
(3) نفسه، ص 11
(4) نفسه، ص12-14
(5) علي المسعودي، تقاطيع، دار الحدث، ط1، الكويت، 1998، ص11
(6) أحلام مستغانمي، ذاكرة الجسد، دار الآداب، ط8، 1998
(7) تقاطيع، ص23، 24
(8) نفسه، ص49
(9) نفسه، ص57
(10) نفسه، ص 65
(11) نفسه، ص 17، 18
(12) نفسه، ص19
(13) نفسه، ص33
(14) نفسه، ص40،41
(15) نفسه، ص41
(16) نفسه، ص27
(17) نفسه، ص69
(18) نفسه، ص71
(19) ليس بهذا الشكل، ص24