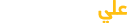يضم
هذا المؤلف الموسوم بـ»شغب» ما ينيف عن الأربعين نصّا موزعة على أربعة محاور هي
على التوالي: «قلب يسكنه وطن» و«أصدقائي شقائي» و«كلام عن الكلمة» و«ما توهمت في
الحب»
ويبقى الشغب ذلك الخيط الرفيع الذي ينتظم فيه مجموع
النصوص. ومن عرف المبدع علي المسعودي عن قرب، لا يستغرب ذلك، فالرجل مشاكس ومشاغب
حتى النخاع.
عندما التقيته لأول مرة، على هامش مهرجان القرين الثقافي
(يناير 2007)، باغتني بشغبه منذ المصافحة الأولى قائلا: «هذا أنا علي المتعوسي».
وذكرني هجاؤه لنفسه بالحطيئة شيخ الهجائين العرب، وأدركت أن الرجل تعيس بهمه
الإبداعي ووعيه الوجودي.
و«الشغب» ليس مجرد نزوة من نزوات الكاتب أو من تعبيرات
مزاجه فحسب، بل مقوم من مقومات الخطاب ومصدر جماليته، يؤسس لشعرية تخترق المتعارف
عليه. والشغب أيضا موقف ورؤية للذات وللآخرين وللمشهد الثقافي ولعالم الناس
برداءاته وفواجعه ومآسيه وأفراحه، بمنجزاته الحضارية وسقطاتها.
يصادفك علي المسعودي الكاتب المشاغب في كل نصوصه وهو
يلقي بحجارته في المياه الراكدة والبرك الآسنة والجداول المطمئنة، يحرك كل المياه
، يرصد ارتعاشة دوائرها المتوالدة، يكتبها نصوصا يحددها هاجس ملحّ، هو هاجس
الانتماء إلى كتابة الاختلاف.
يعلن عليك علي المسعودي شغبه بدءا من صفحة الغلاف، حيث
تطالعك ملامح الكاتب في شبه صورة نصفية هي أقرب ما تكون «للكليشيه» بالأسود
والأبيض. تقول لك ابتسامته الساخرة: «هذا أنا.. لا لست أنا.. أتحداك إن استطعت أن
تحمّض الصورة وتعرف من أنا.. لأني كائن متعدد يمتلك أكثر من أنا..».
العصيان الأجناسي: من أجل نصّ مختلف
أمّا الانتماء الأجناسي لهذه النصوص فلن تظفر به بيسر،
رغم أن الكاتب قد أدرج بالبنط الصغير، على هامش الصفحة الثانية، نصا موازيا يحمل
العنوان التالي: «كتبت هذه المقالات بين 1998 و2001 في مجلة المختلف، عبر زاوية
(شغب) الشهرية وأضيفت لها مقالات نشرت في أماكن مختلفة». هل نسلم بهذا التصنيف
الإجناسي الذي وسم به الكاتب نصوصه وقد اعتبرها مقالات، هكذا وبدون تخصيص؟
غير خاف على القارئ أن هذه النصوص تجاوزت حدود المقال
الصحافي الذي يقوم على مراعاة الغاية النفعية في رهانه أساسا على توصيل المعلومة
للقارئ في نطاق استراتيجيا إعلامية تروم الإخبار والتثقيف والتوجيه والتعليم. هذه
النصوص، كانت في حلّ من إلزامات المقال الصحافي بحكم أنها تنزلت في فضاء زاوية
خاصة بالكاتب، بما يتيح له التعاطي مع الكتابة بلا تكليف أو قيود وشروط مسبقة. وقد
عرف المسعودي كيف يغنم فسحة الحرية، فاختار أن يتوجه بنصوصه إلى فئة مخصوصة من
القراء المهتمين بالشأن الثقافي والإبداعي. بهذا نفسّر ما تميزت به هذه النصوص من
احتفاء باذخ بفعل الكتابة لغاية تحقيق جمالية التلقي.
الهمّ الأدبي حاضر في كلّ نصوص المسعودي إلى حدّ الهوس
بإيقاعات «نبضها الأدبي» غير آبه بمسألة التصنيف الأجناسي، وكثيرا ما يقحم في
فضاءات النصوص بيانات أدبية يصف فيها موقفه من الكتابة والأجناس الأدبية، من ذلك
قوله:» فأنا حين أكتب أكون لا ضدّ ولا مع أيّ جنس أدبي.. إلاّ مع خفقان الأجنحة
المعذبة.. مع نبضات الأدب وهي تخفق في الشرايين.. (انظر «أقاصيص مكبلة بوحدة
الشهقة»، «شغب»، ص 41).
الانتصار لفعل الكتابة وحده ودحض الحدود والفواصل بين
الأجناس الأدبية من المطالب التي رفعتها النصوص الحداثية، من أجل أن تسود قيمة
أساسية هي قيمة الإبداع. هكذا نتبين أن ما اقترحه علينا علي المسعودي في هذا
المؤلف، ليس «مقالات» كما أوهمنا ، بل نصوص إبداعية أعلنت عصيانها للتصنيف،
تتنازعها انتماءات شتّى: الشعر والخاطرة واللوحة الفنية والقصة القصيرة والحوارية
وأوراق من يوميات وسيرة ذاتية وغيرية ورسم بالكلمات «بورتريه»، لوجه الكاتب ذاته
أو لوجوه بعض المبدعين والفنانين ممّن ينتمون إلى حزب الاختلاف، إلى جانب تشكيلات
أخرى من الوجوه، سنعرض لنماذج منها لاحقا.
يمعن علي المسعودي في مطاردة النصّ المختلف في مكونات
خطابه ولغته سواء بسواء. وقد تتداخل سجلات الفصحى بالعامية ويتلبس الوصف بالسرد
والتأملات بالاعترافات والجدّ بالهزل والرسالة بالحوارية والخيال بالواقع، في النص
الواحد. وللمسعودي شأنه الخاص جدّا في حياكة أحابيل الفتنة التي تتخلل نصوصه، وهو
لا يطمح فحسب لتحريك سواكن القارئ والإيقاع به في أحابيل النص، بل يراهن أيضا على
أن يعجب القارئ بشخصية كاتب النصّ، لذلك ترشح نصوص المسعودي برواسم الذات الكاتبة
، فهو من صنف الكتّاب الحداثيين المشاغبين الذين لا يعترفون بمقولة «موت الكاتب»،
فاتجهوا نحو ترسيخ حضوره في فضاءات النصّ باعتباره الطرف الأساسي في العملية
الإبداعية. فالكاتب هو ثالث الأثافي أو أولها على الأرجح: الكاتب والنصّ والقارئ.
لعبة «الأنا»
نصوص المسعودي تبطن رغبة ملحة في إقامة ذلك الأفق
التواصلي مع القارئ، متخذا لنفسه مقام الكاتب المحاور، لا العارف المتعالي او
المبشر بقيم مثالية. المسعودي الكاتب لم يخف عن قارئه أنه كائن بشري خطّاء، ولئن
حمل ميزة همّ الكتابة، لذلك لم يتردد في الكشف عن تناقضات علي المسعودي الكائن
البشري، إلى حدّ الجلد الموجع للذات المعذبة في مختلف حالاتها: الانكسار والصمود
والمعصية والبراءة والنزق والاستقامة والشجن والفرح والنجاح والفشل والصدق
و»الافتراء» والحلم والواقع..
وجوه تتشكل في فضاءات النصوص
يتعاطى علي المسعودي في جلّ نصوصه، لعبة تشكيل الوجوه في
مراوحة متصلة بين استجلاء الملامح المميزة للشخصية/الوجه وسبر جوانبها ورصد
أفكارها ومواقفها وإضافاتها الإبداعية التي تبدو في أغلب الحالات، ذات صلة بتركيبة
مزاجها. يبدو أن المسعودي القاصّ وظّف للغرض أساليب الاستبطان والتحليل السيكولوجي
والتداعيات وفنيات رسم «البورتريه» أو الصورة النصفية التي لا تقتصر على المظهر،
بل تشف عن خلاصة الجوهر الكامن في أعماق الشخصية. كل ذلك من خلال عملية مزج بارع
بين الواقع والخيال، مستفيدا من ملكاته الفراسية وخبرته المكتسبة بمعادن الرجال
والنساء.
ولم يستثن المسعودي نفسه من اللعبة، فقد تعددت وتنوعت
محطات الانعطاف على الذات في الزمان والمكان، فنراه يستغرق في مرآة النص يتملّى
صورته ويرسم لنا «بورتريه» ذاتيا (Auto-portrait) يحمل
وجهه، وجها بملامح تتحول باطّراد، مصطنعا نوعا من المسافة مع ذاته، فتتحول الأنا
إلى آخر يعيد تشكيل وجهه من جديد، يواجهه تارة بضمير أنت أو يتخذ منه وجها موصوفا
بالوكالة، وقد حصره في ضمير الغائب «هو».. بين المقامات الذاتية والغيرية نكتشف
وجه المسعودي الطفل ثم اليافع ثم الشاب ثم الرجل الذي وضع قدمه على عتبة الكهولة،
المسعودي الإنسان والمبدع وهو يرزح تحت أوزار المعاناة والهموم الذاتية والوجودية
والقومية.
شاء له قدره أن يكون من مواليد نكسة أو هزيمة 67، إن لم
يحلّ للوجود على مرمى أشهر منها، فهو إذا من أبناء الهزيمة، وسيكون له موعد مع
الفواجع. من ذلك موت الأم وهو لم يتجاوز سنّ السابعة. في نص «خاص جدّا» يرسم لنا
وجه طفل يتيم يواجه موقف الفقد الصعب – فقد الأم – فيصدر عنه سلوك غير مألوف، كأن
لا يبكي الأم الفقيدة على غرار شقيقه، ويقول في ذلك:» كأنني أجلت حزني إلى أن
أكبر، حتى أعطي الحزن حقّه، أو كأن أمّي هي التي يجب أن تحزن لأنها تركتني وحيدا..
غريبا» (ص12). وتتنوع تجليات الحزن على وجه المسعودي يستثيرها فقد الأصدقاء
والأحباء وأحوال الضياع والغربة الوجودية وسط الزحام وهواجس العذاب والموت
والتفاهة.
وفي نصّ «حديث الروح» يحادث المسعودي وجه «التافه»
المتخاذل في خطاب مغرق في التقريع والسخرية السوداء: «تافهون كثّر حققوا مراكز
أفضل ممّا حققت ونالوا أكثر ممّا نلت وعلا صوتهم صوتك .. يا إلهي، أنت حتى في
التفاهة فشلت» (حديث الروح، ص 15).
وجه الطفولة
ويبقى وجه الطفولة « أكثر الوجوه إشراقا»، فهو الملاذ
والمهرب، على غرار الرومانسيين، يهرع المسعودي إلى مرابع الطفولة ليقف على أطلالها
عسى أن يسترجع الطفل الذي كان ويتبين «بالصور المخزنة في الورق الصقيل» (حسب
تعبيره)، ليتبين ما طرأ على وجهه من تحولات: «إن الطفل المخزن في الورق المصقول هو
أنا الذي لا يمتّ إليّ بصلة، إلا عندما ينظر إليّ نظرات مشحونة بالعاطفة. لا
أستطيع مقاومة الإطلال عليها أو مجابهة ما تحمله من تفاصيل صغيرة تئن في قاع الروح
وتدقّ في أقاصي الذاكرة وتلعب في خفقات القلب.. هذا هو أنا، طفل كبر وتلوث وتعلّم
وحاول أن يطهّر نفسه، كما حاول أن يكون صادقا مرّة وطيّبا مرة وشرسا مرّة وإنسانا
مرّة ونصف إنسان مرّة.. هذا هو أنا علي المسعودي: طفل وشاب ورجل عرف أن الرهان مع
الزمن، هو الرهان الوحيد المستحيل مع الحياة.. لذلك أصبح ينظر إلى وجه ابنه «باسل»
ويقول له: أذكرني « لأن كل ما فوق التراب، تراب» ( نص «اعتقال لحظة هاربة من
العمر»، ص 9).
هذا المقطع الذي أدرجناه، يحمل همّا «سيرذاتيا» يلازم
الكاتب في العديد من النصوص، حيث نصادف نتفا من سيرة ذاتية لأن المسعودي أدرجها
كما اتفق دون أن يلتمس لها بداية أو نهاية أو يعلن عن ميثاق «سيرذاتي» صريح. كأنما
هو مهووس برسم وجوهه أكثر من الانكباب على سيرة حياته. لهذه الاعتبارات، يمعن
المسعودي في ملاحقة وجهه، فيوظف للغرض اليوميات واللوحات الفنية والتأملات والقصة
والرسالة والحوارية والاعترافات والتداعيات وآليات التناص، ممثلة على الخصوص في
تلك النصوص الموازية أو النصوص العتبات التي تحتل مرتبة الصدارة من كلّ كتاباته
وتمثل طقسا من طقوسها، فضلا عن كونها تشي بالمرجعية المعرفية للكاتب. فالمسعودي لا
يخفي ولعه بمحاورة وجوه معروفة من الكتّاب والشعراء والفنانين الذين تميزوا بقيمة
إبداعاتهم، ولا غرابة في أن يكون المسعودي الكاتب ضمن «مجمع الكتّاب» الحاضرين في
صالون نصوص مؤلف «شغب». يكفي أن يصطنع الغيرية ويجترح من ذاته ذاتا أخرى تحاور
سميّها علي المسعودي، متوسلا بقناة «الرسالة» التي سرعان ما تلتبس بالحوارية، وهو
ما نكتشفه في ذلك النص الطريف الذي يتوجه به علي المسعودي لعلي المسعودي المبدع:
«العزيز علي، لا يمكنني إلاّ أن أمتدح الزهور وهذه الطريقة العابقة في استتباب
الذاكرة وأنت تنثرها بذورا لكنك حين ترشها بالماء السلسبيل تراها وقد أطلت برؤوسها
اليانعة الخضراء مبتسمة بوجه إشراقة الشمس.. تلك القطع زاهية رائعة مثل وردات
حيّية عاطرة يمكنك أن تقول إنها «نصّ أدبي» دونما تحديد لجنسها. يمكنك أن تقول هي
أقاصيص مكبّلة بوحدة الشهقة...» (نص «أقاصيص مكبلة بوحدة الشهقة»، ص 40).
على هذا النحو يجمع المسعودي بين حرفية القاصّ ومهارته
في رسم الوجوه وبناء الشخصيات وسبر الأحوال السيكولوجية ودور الملاحظ/الشاهد على
المشهد الثقافي والفني وعلى الواقع المعيش عموما، فالحس النقدي المتيقظ لديه يخترق
كل النصوص تقريبا.. لا مراء في أن متعة القراءة مضمونة لقارئ نصوص «شغب»، نظرا لما
تتوفر عليه من قيمة جمالية.
بقي ثمة سؤال ظل يلحّ عليّ وأنا أقرأ هذه النصوص: لماذا
أقدم علي المسعودي على إجهاض العديد من القصص القصيرة ليختار نصّ المقال بديلا
عنها؟