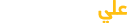"يرتدي ملابس المدرسة في صحراء بعيدة.. يخرج قبل الخامسة فجرا، كي يدرك
طابور الصباح.. يؤوب وقد شارفت الشمس على المغيب.. رجوع إلى الرمل بشروط المدينة؛
لا ذئب، لا بيت شعر، ولا حنين ناقة". هل يكتب علي المسعودي مذكّراته أم
مذكراتي؟ هل يروي تاريخه أم تاريخ جيل كامل تشظّى، في سبيل طلب الحلم، على مفترقات
الطرق المستحيلة، قبل أن يكتشف أنه لم يغادر بيته الأول أبدا؟
لا يحتاج من عاش تحولات الزمن في سبعينيات القرن
المنصرم وثمانينياته في الجهراء، وما يشبهها من مدن الكويت وقراها الأخرى في
تركيبها الديموغرافي لإجاباتٍ عن تلك الأسئلة التي ما زال يتقلب على جمرها في
محاولاته الدوؤوب للعيش في هوية وطن.
وطالب الحلم الذي كتب مذكراته بهذا العنوان هو
القاص والإعلامي، الزميل علي المسعودي. كتب مذكراته على سبيل جمع وتدوين بعض
الذكريات التي تداهم كل من غادر الخمسين من عمره للتو، في محاولة منه، لا للتشبث
بما مضى من سنوات وحسب، ولكن أيضا للتخلص من ثقل وطأتها على النفس أحيانا، بما
تحمله من تحولاتٍ وتقلباتٍ ومفاجآتٍ لا بد منها، مهما بدت لنا وتيرة الحياة تجري
بهدوء نهر قديم. لا بد للنهر من حكاياتٍ يرويها للضفاف والشطآن المتغيرة، ولا بد
له من تاريخٍ جامحٍ يبرر منعطفاته اللاحقة. هكذا قرأت مذكرات المسعودي الذي يجايلني
في زمنٍ متشابه، وظروفٍ تكاد تكون متطابقةً بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة، لا في
البدايات البعيدة على حواف وطن عصي على الاعتراف بك إلا كنتوء صحراوي، يداهم نداوة
البحر وما يمتد أمامه من فضاءاتٍ وحسب، ولكن أيضا في النهايات التي نعيشها الآن
باعتبارها بداياتٍ جديدةً في ظروفٍ قد تكون أفضل، مقارنة لها بظروفنا المعيشية
القديمة، ولكنها، في حقيقة الأمر، ليست سوى ترسيب لها في قاع الروح، يأبي أن
يذوب.. ولن يذوب أبدا.
صدّر المسعودي كتابه الممتع بعبارةٍ لعلي
الطنطاوي "كانت المدارس كالبئر، ضيقة الفوهة ولكنها عميقة القرار.. فصارت
كالبركة الضحلة واسعة الرقعة، لكنها قليلة العمق". وعلى هامش الفكرة، كتب
طالب الحلم مذكّراته من بين قاعات الدروس وساحات المدارس المختلفة التي درس فيها،
والطرق التي تؤدي إليها بالضرورة، على الرغم من اختلاف العناوين بين المدينة
والصحراء.
يستعيد الكاتب لقطةً من طفولته المدرسية، فيرسمها
هكذا؛ "أذاكر على ضوء سراجٍ يُضاء بفتيلة منقوعة بالكيروسين.. أشم رائحة
انطفائها كلما استعادت ذكراها". وأقف أنا عند اللقطة مختنقةً بتلك الرائحة
التي تغمرني في اللحظة ذاتها، والتي تفصلني عن لقطتي الخاصة المشابهة لها أربعة عقود
تقريبا.. الرائحة ذاتها تهيمن علي، وأنا أكمل قراءة مذكراتٍ كان يمكن لكاتبها أن
يحولها، وهو القاص الموهوب، لروايةٍ حقيقيةٍ بلا أي ادعاء، لولا أنه، كما يبدو لي،
أراد أن يحتفظ بحميميتها ومعناها الحميم في تكوينه الثقافي والنفسي.
يعلق الكاتب، في نهايات كتابه، على أبياتٍ شعرية
لشاعر يتحدّث عن أهمية الكتابة، بمعنى التدوين في تحصيل العلم: "إن لم تقيد
غزالتك ضاعت منك". وعلى سبيل استرجاع لذائذ العمر المتصرم وأوجاعه، قيد
المسعودي غزالة العمر المتفلتة في هذا الكتاب الساحر حقاً، والذي توقعت أن يكون،
وأنا أقرأ عنوانه، سيرة ذاتية، لكنني وجدته أكثر من ذلك في أجزاء منه، وأقل في
أجزاء أخرى.
في الصفحات الأولى من الكتاب، يحكي الطفل الصغير
عن حادثة ضياعه في رحلة العودة إلى البيت، بعد أن صعد حافلة المدرسة الخطأ، ولم
ينقذه من ذلك الضياع إلا طالب نابه، كان يعرف منزل ذويه، فأرشد سائق الحافلة، قبل
أن يكتشف الطفل لاحقا حقيقةً يمكنها أن تكون خاتمة مثالية لتلك المذكرات؛
"اكتشفت عندما كبرت قليلا أن المكان الخطأ الذي ذهبت إليه في ليلة الضياع تلك
لا يبعد عن حارتنا سوى كيلو مترات قليلة..".
نعم.. نكبر كثيرا، وتتشعب بنا اقتراحات الحياة في
أماكن شتى، ولكننا نكتشف، في نهاية الأمر، أو قبل النهاية بقليل، أننا لم نبعد عن
حارتنا الأولى سوى كيلو مترات قليلة، لكنها كافية لتجعلنا أكثر إصرارا على الحياة
في سبيل الحلم.