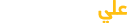"ويا ويح قلب من رحلت أمّه في سنّ الطفولة. فقد غاب عنه الكثير من الأنس والحنان والاهتمام. ويا لحزن اللغة العربية التي لا تسمي فاقد الأم يتيما"!
التقط قلبي هذه العبارة من كتاب الأديب علي المسعودي: " مذكرات طالب حلم". هوت بمطرقة عملاقة على قلبي الذي فقد منذ عام تقريبا أحنّ إنسانة في الوجود: أمي. وكنت في روايتي الأخيرة " شارع الدبوس" أتحدث عن يتم الطفل عندما يفقد جدّه بالموت المفاجئ ليصبح يتيم الجدّ. وقررت بأن ذلك الطفل قد أصبح يتيما بالتأكيد، حتى لو كان الذي مات جدّه.
في سيرة المسعودي " المخفّفة" أو المتلطّفة كي لا يتسبّب بصدمة كبيرة للمتلقين الذين يعنيهم هذا الكتاب، رأيت أكثر من يتم. فبالإضافة إلى يُتْم الأم المبكر (في سنّ السابعة تقريبا) يبرز كالبرزخ يُتْم الهوية مسنّنا وحادّا، على امتداد العمر الذي يبحث في أزمة التعليم. ينبعث مثل منجل عملاق لحصد الأرواح المعذّبة. يتم الهوية يكبر من (المكان في الصحراء إلى .... المدرسة التي من المفترض أنها ستحل هذه الإشكالية لكي يصل المسعودي إلى يتم التعليم نفسه).
هناك أمثلة لا حصر لها لليتم الذي يخلّفه الموت، لكن اليتم الذي تخلّفه الحياة يبدو مثل عذاب أبديّ لا يتركنا نحيا:
" كلما بلغ الحنين أقصاه لذلك الطفل طالعت وجهه في المرآة. طفل يملأ الشيب وجهه، وفي عينيه حزن معتق وإرهاق طويل وآلاف الخطوات"...
هناك من ليس لديه مشكلة في الهوية الورقية كطائرة المسعودي الورقية، ولكنه ينوء بمعاناة الهوية الاجتماعية التي تسبّب له يتما اجتماعيا، إن لم أقل عزلا اجتماعيا أليما. إلى الدرجة التي يصبح فيها ألمه أشدّ وطأة من فاقد الهوية الورقية:
" في ذاكرتي أصوات وصور وحيطان، وشوارع وبيوت، وأطفال وأمهات وأزقة، وحنين، ودمع كثيف، ورفرفت قلب... ورائحة برتقال".
كلّ ما سبق كان مخزّنا على امتداد عشرات السنين! وها هو يخرج كمذكرات لطالب حلم بحياة أجمل.
يورد كافكا في رسائله إلى ميلينا قصة أول عمل لدوستوفسكي حين فرغ منه فجر تلك الليلة ليأخذه صديقه وزميله في الغرفة جريجورييف، ويطير به إلى الناقد الشهير آنذاك نكراسوف. ثم يأتي الإثنان إلى دوستوفسكي في الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، لينهالا عليه بالعناق وهو مبهور ما بين اليقظة والحلم. لم يكتف نكراسوف في تلك الفجرية بعناق دوستوفسكي بل أطلق عليه لقب أمل روسيا. خرجا منه عند الصباح لكن هذه الساعات التي قضياها معه خلّدها الأديب الروسي بعد ذلك في كتاباته بأنها من أسعد أيام حياته. خرجا وانحنى على النافذة يتبعهما بنظراته وهو يبكي بكاء مرّا وشديدا لا يدري من الفرح أم من شيء آخر وصفه فيما بعد: هؤلاء الناس الأصلاء، يا لهم من نبلاء وطيبين، ويا لي من زائف، آه لو أتيح لهم فقط أن ينظروا في أعماقي! ولو كان لي أن أقول لهم ما خفي عليهم، فقد لا يصدقون قولي"!
ماذا لو لم يعد جريغورييف في ذلك الفجر! ماذا لو سرق مخطوطة الرواية؟!
لو قُدّر لي أن أرى
المخطوطة قبل نشرها لخطفتها ولكن لجعلت صديقي علي المسعودي يكمل النصف الأول في
كتاب ويجعل النصف الثاني من هذه السيرة في كتاب آخر. ولما عدت إليه في فجر اليوم
التالي ومعي أحد من النقّاد. لأن النقّاد ماتوا!
الكتابة جحيم. وما قد تحسبه فردوسك قد يكون هو الجحيم. وعليه فإنني أؤمن بأن الكتابة خلاص حتى لو كان هذا الخلاص نفسه تعذيبا
لمرة أخيرة. ولعلّ المسعودي أراد أن يتخلص من عذاب الذاكرة المنسي من حياته.
العذاب المقيم إقامة تامة في روحه.
كل كاتب يحلم بأن يكتب المخفي والمستور
ويسأل نفسه متى يكتب نفسه لكي يتخلّص من أعبائها؟
عندما قرأت منجز صديقي المسعودي في هذه السيرة تساءلت إن كان قد شعر بالراحة بعد هذه السيرة التي أسماها مذكّرات طالب حلم. السيرة أكثر خطورة. إنها دروب وعرة. بلا نهايات محددة كالقصة أو الرواية. هنا الكاتب يكتب لنفسه، وليس للآخرين. كيف له ألاّ ينفجر انفجارا تاما. فهو لا يقلّ عن أيّ بركان.
لكنني وجدت أن سيرته
جاءت مثل كتابة من يخاف من البلل وسط الأنهار.
كونه، إنسانا وكاتبا،
ما يزال فعّالا في الوسط الخارجي، وقد نجا حتى الآن من الحياة، منح ذلك الكاتب
القدرة على قمع الداخل الذي دخل في سبات طويل. حفاظا على الوسط الخارجي لا حفاظا
على الذات المتشظّية. ما حقّ الذات على الكاتب؟ أن يطمس ما تعرضت له أم يخرج
ذكرياتها؟ بين هذا وذاك راوح المسعودي. إذ خرج ذلك الداخل في تسعين صفحة، من أجمل
ما كتب المسعودي الذي جاء إلى الكتابة بعد عمر أنهكته حروب الهوية والمكان
والتجارب و"آلاف الخطوات".
أتذكّر بأنني عندما قرأت الخبز الحافي لمحمد شكري قبل أكثر من عشرين عاما أصبت بالرعب. أشبّه هذه الحالة بمريض ينتظر دوره للدخول على الطبيب، فيسمع صرخات المريض الذي قبله فيصاب بنوبة رعب. لو كتبت كما كتب محمد شكري لمتّ من فوري. يقترب علي من حافة الكتابة الهاوية، ينظر إلى داخله ثم يتراجع عن التفاصيل خشية أن يكون كافكويا؟ كافكا الذي اعترف بأن من يختلط به سيعاني أشدّ العذاب.
إذا كان الكاتب لديه علاقة غير عادية مع العالم فلماذا يكتب بعاديّة إذن؟ عليه أن يقتلع أيّ سقف يفصل بينه وبين السماء. أردت كصديق وككاتب وقارئ أيضا يؤمن بقدرات علي المذهلة في فن القص والسرد، أن تستمر السيرة منطلقة من تلك المنطقة التي أسميها جوف الروح. لكنها توقفت بعد الساعة التسعين. ومع ذلك لم يخلُ ما أكمل به كتابه الحلم من فائدة عظيمة عن التعليم. عن وعي استثنائي. عن وعي نادر لمدرس لم يكن. أراد ولكن أطاحت بحلمه الهوية و... الفقد. الفقد المتعدّد. للأمّ. للهويّة. للمكان.
يبدو الخوف بوصفه خامة إبداعية وأدبية قماشة "كانفازا" للوحة السرد. ما أجمل السرد حين تصدّره غواية الحبّ وغنج العذاب المستتر في الروح.
طرح هذا عليّ وأنا أقرأ مذكّرات طالب حلم سؤال الكتابة؟
طبعا العنوان نفسه
يمسك بكلّ الأزمنة، فكلمة مذكرات تحيلني إلى الماضي. وكلمة طالب تفسّر لماذا تمسّك
الكاتب طوال عمره بالدراسة، أما كلمة الحلم فتحيلني إلى هذا الإصرار، الذي يستغرق
عمرا بأكمله، على الرغم من عدم تحقّق تلك الآمال العريضة التي كوّنت الطفل الذي
كان.
أعود لسؤال الكتابة.
حين كتبت شخصيّا كتبت وأنا محمّل بالخوف من العار الذي قد يلحق بي جرّاء كتابتي. الكاتب العربي يخشى العار. عار الأفكار وعار الكشف. يبدو الكاتب العربي وقد هبّت عليه عاصفة من أوراق أشجار بعيدة ليس من أشجاره ثم عندما هدأت العاصفة سقطت هذه الأفكار- الأوراق وبقيت شجرة الإسلام العملاقة. هويته الأصلية حتف أنف التغريب.
هل يكذب الكاتب أمام
"أستاذ" القرّاء؟ يلفّ ويدور؟ يواري سوأة مجتمعه؟
يلجأ بعض الكتّاب إلى الكتابة في الليل خوفا من الافتضاح. وإلى الكتابة في الصباح
خوفا من الأشباح.
كم من مرّة قلت لنفسي:
حسنا جدّا... هذا يكفي، سأكتب ما يضرّ بي. وليكن ما يكن. فالكتابة أضرار وإضرار.
لكن ليست كلّ كتابة ارتطاما بالواقع. أتراجع. ثم أفور كما
البركان لأكتب. هكذا يراوح الكاتب العربي ويموت دون أن يكتب ما في نفسه أو "
ما نفسه فيه"!
السيرة وجع تنكأ جراحاته وتشقّقاته بكامل إرادتك. عملية جراحية معقّدة. لذا على الكاتب أن لا يترك الجرح بلا تنظيف وتخليص.
سأكتب عمّا فعله الآخرون بي. لكن ماذا عمّا فعلته أنا لغيري؟ أعني ما تسبّبت به من جراحات وآلام وعذابات للآخرين طوال حياتي؟ كنت مشغولا بهذا السؤال عن كوني مظلوما من الآخرين. سأكتب ضدّ نفسي. ضدّي. ما كان يهمني طوال الوقت كيف سأكفّر عن سيئاتي وأخطائي عبر الكتابة، وليس كيف أكتب عمّن ظلموني؟ وأساؤوا لي، عن أولئك الذي أحالوا عمري إلى جحيم لا يتوقّف إلا بالموت.
أعرف تماما مثل المسعودي بأن الحياة: "أصبحت تتسع أكثر للكاذبين ولا تتحمّل وجود الأبطال حتى في الخيال"!
هل أكتب عنهم وأرتاح أم أكتب عني لكي يرتاحوا هم مني؟ من حمل هذا الضمير المشاغب والقاسي؟
: "من بعيد لوّح لنا أحد صبية الحيّ الذين نلعب معهم نهارا، نادى بصوت مرتفع وهو في مكانه:
محمد .... علي
أمّكما ماتت!
... وخزة مؤلمة انتقلت من صوته واستقرّت في قلبي ما زلت أشعر بها...
منذ تلك اللحظة التي تقطر دمعا وألما ابتدأت الحكاية. لا... ابتدأت قبل ذلك. لكن هذه الصيحة من طفل من بعيد كانت البداية الحقيقية للأسى.
في الجزء الأول من سيرة طالب حلم التماعات فكرية وموقف عميق من هذا العالم تمنّيت أن يستمر حتى آخر الكتاب" يضحك الكبار من طائراتنا التي تتحطّم بسرعة لكنها لا تقتل أحدا مثل طائراتهم"!
لعلّ المسعودي يعيد النظر في الطبعة الثانية من هذه السيرة. أدباء كبار أعادوا كتابة كتبهم.
يبدو سؤال المكان القاحل القاهر متفجّرا في هذه الجملة التي لها القدرة على التشظّي إلى آلاف القنابل العنقودية:
"لم يشعر موظفو البلدية وهم يجرفون البيت بأن الطفل هو الذي كان يتهدّم"!
هنا ماتت الأم. حتى يتم الأمومة جرفته تراكتورات البلدية!
عندما أمرّ بين فترة وأخرى على البيت الذي كانت فيه أمي أوقف سيارتي وأسلّم عليه وأنا أبكي مخاطبا إيّاه: " يا بيت لست مكانا يا بيت ... بل أنت قلب أمي الذي توقّف هنا" !
يا للحزن الهائل. هذه السيرة العذبة والأليمة من أجمل ما قرأت أخيرا. وعلى المسعودي أن يكملها ....